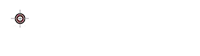08:04 2020/11/06
04:22 2020/04/02
11:31 2020/03/10
الشاعر الكبير عبدالله البردوني كما عرفته عن قرب
08:33 2020/09/05
1- مقدمة:
ليس ما أكتبه هنا بحثاً أو قراءة نقدية، بل مقاربات تسترجع أبعاداً من واقع مازال حياً ونابضاً في الذاكرة والوجدان لما يزيد عن خمسين عاماً من صداقتي لشاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني، منذ أول لقاء جمعني به في صيف 1957م حتى رحيله إلى عالم الخلود في صيف 1999م. وبدايةً أود تأكيدَ حقيقة أنه ليس هناك أصعب من أن تكتب عن شاعرٍ تربطك به علاقة حميمة، وقد تأخذ الصعوبة مداها عندما يكون الحديث بإيجاز متجاوزاً بعض التفاصيل التي قد تبدو في مثل هذه الحالة بالغة الأهمية لما قد تكشف عنه من خفايا، وتشير إليه من وقائع ذات دلالات خاصة.
إن الجليل والجميل في سيرة هذا الشاعر الرائي تكمن في استطاعته التغلب على المعوقات التي كانت تقف في طريقه، وكان بعضها كفيلاً بأن يحول بينه وبين ما تحقق له من نجاح وشهرة في دنيا الإبداع. ويعود الفضل في هذا إلى إرادته أولاً، وثانياً إلى طموحه اللامحدود، فلم يعرف التردد أو الضعف طريقهما إلى نفسه الكبيرة وإرادته القوية.
وحين أستعيد شريط الذكريات تبدو لي لقاءاتنا، التي كانت شبه يومية، غير عادية ولا عابرة، بل كانت تتصدر قلب المشهد الثقافي والشعري منه خاصة، كما تتطرق إلى الشأن الثقافي العربي من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، و تتناول بالتفصيل الحديث عن الكتب التي كنا نقرأها أو نكون في طريقنا إلى قراءتها، وعن المجلات الأدبية العربية تلك التي تحملها الصدفة إلينا وتتسلل إلى صنعاء من عدن عبر أشخاص مغامرين رغم أنها لا تُعنى بالسياسة، وتتمحور موضوعاتها حول الإبداع والنقد الأدبي. وأهم هذه المجلات في ذلك الحين وأكثرها تأثيراً في الذاتية الأدبية مجلة "الأديب" ومجلة "الآداب" البيروتيتان. وأعترف سلفاً أنني حاولت قبل البدء في كتابة هذه المقاربات أن تأخذ أسلوباً سردياً خالياً من التكلف والتعابير المنتقاة، تلك التي قد تقف حجر عثرة في طريق القارئ وتكسر سياق السرد وعفويته، وقد تخيلت قارئاً يريد أن يعرف أهم المراحل في حياة شاعرٍ فريد في حياته، وقراءته في شعره وفي نتاجه الأدبي الذي يجمع بين المقال والكتابة التاريخية التي تقوم على وجهة نظر في ما حدث وتم في حاضرنا غير مقيدة بالمراجع.
ولا أزعم أن هذا الاستدعاء لمشاهد من سيرة الشاعر قد أحاطت بكل ذلك، أو اقتربت من الإحاطة. فهناك عناصر كثيرة غائبة في المشهد قد يكون لآخرين غيري علم بها وبمؤثراتها المباشرة على بعض مواقف الشاعر وقناعاته السياسية والفكرية، وقد يكون في دراسة شعره واستخلاص بعض جوانب مهملة من حياته ما يضيف ويكشف عن زوايا لم تتطرق إليها هذه الشهادة. وفي بعض القصائد المطولة كقصيدة "حكاية سنين" على سبيل المثال ما يعد خلفية مهمة لبعض الأحداث التي عاشها الشاعر وانفعل بها، ومن أوضحها – في القصيدة- ما ارتبط بمصرع الشاعر الكبير محمد محمود الزبيري، وما أحاط برحيله الفاجع في غموض وتعدد في الراويات والاتهامات. وسيجد القارئ منذ بداية هذه المقاربات حضور الشاهد الذي يقوم بدور السارد أو الراوي، وهو أمر تصعب مجاوزته والاستغناء عنه في تقديم صورة واقعية قريبة من الحقيقة كما تجسدت في الذاكرة وصارت جزءاً لا يتجزأ من ثوابتها. ومن حسن الحظ وفضل الله أن تطول المعايشة وتتواصل بيننا، ولم يحدث ما يعكّر صفوها أو يؤدي إلى انقطاعها كصداقات أخرى كثيرة توقف بعضها في بداية الطريق وتوقف الآخر منها في منتصفه. وأعترف أن لصديقي الشاعر الكبير اليد الطولى في بقاء صداقتنا في منأى عن التلوث العام وما يصدر عنه من خصومات وخلافات على درجة من الضحالة والإسفاف.
2- البردوني عن قرب
نصف قرن من الزمن جمعني بالشاعر الكبير، وهو زمنٌ يماني مليء بالمضحكات والمبكيات، كان أنقى وأبقى ما فيه الشعر والصداقة التي تحدّت حساسية المعاصرة والثنائية الضدية. ولا جديد أو مبالغة في القول بأنه كان قريباً إلى نفسي كما كنت قريباً إلى نفسه وهو القرب الذي لا يعني التماثل فقد كان لكل منّا وجهات نظره الخاصة التي يختلف فيها عن صاحبه. وربما يكون الاختلاف الواعي أدعى إلى استمرار الود ودوام الصداقة. فهو يجعل الأبواب مشرعة للحوار والقراءة الموضوعية لمستجدات الواقع والإضافات المتلاحقة في مشهد الإبداع الأدبي. وكان البردوني في بداية الأمر، وبعد تجارب مريرة وقصيرة، يخاف السياسة ويهرب إلى الطبيعة وإلى كتابة القصائد الوجدانية. كما كان في كل الحالات يحب الحياة ويقبل عليها بنهم شديد دون تهوّر أو ابتذال وفي حدود ما يسمح به الواقع البخيل والمقتر، وكان نهمه إلى القراءة أو بالأحرى إلى الإصغاء إلى من يقرأ له أكثر من أي نهم آخر. وقد قرأت له بعض الكتب التي كانت متوفرة في مكتبتي ومنها قصة الفلسفة لأحمد أمين وزكي نجيب محمود وقصة الأدب في العالم ترجمة زكي نجيب محمود وبعض الروايات العالمية المترجمة عن اللغتين الروسية والفرنسية، فضلاً عن دواوين بعض الشعراء المعاصرين أمثال الشابي وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي ومحمود حسن اسماعيل. وكان قد فرغ من قراءة الشعراء القدامى واستظهر الكثير من أشعارهم.
والإشارة هنا إلى القراءة تجعلني أتوقف لكي أقول إنه كان دائم الشكوى من بعض من يقرأون له من ذوي الثقافة المحدودة، وما تتركه القراءة المغلوطة من لبس بعض المفاهيم، وكان يقول إنه لا يتوقف كثيراً عند الأخطاء النحوية التي يرتكبها هذا النوع من القُرّاء فقد كانت معرفته بقواعد النحو تجعله يتجاوز عن رفع المنصوب وكسر المرفوع وقد انتظر طويلاً حتى وجد القارئ المناسب الذي تحول إلى رفيق دائم يشاطره في رحلاته وإقامته ويكتب ما يمليه عليه من قصائد ومقالات بخط واضح وكلمات صحيحة الإملاء، وهذا القارئ المناسب هو الأستاذ محمد الشاطبي الذي ظل يرافق الشاعر الكبير إلى أن أسلم الروح، وبقى أميناً على آثاره المخطوطة بما في ذلك قصائده القليلة جداً التي لم تنشر وقد تكاثرت حولها التكهنات والأقاويل.
وهنا، وليس في أي مكان آخر من هذه الشهادة، أضع بين قوسين كبيرين انطباعاتي الأولى عن الشاعر الكبير الذي صار صديقي، وعن أول قصيدة قرأتها له واستظهرت عدداً من أبياتها، فقد كنت في السادسة عشرة من عمري أعيش في مدينة صغيرة خارج العاصمة، وفي ذلك العمر بدأتُ أكتب محاولاتي الشعرية الأولى بتشجيع من أحد أساتذتي، كما بدأت أتابع ما يُنشر في صحيفة "النصر" الإمامية من شعر المناسبات، وكانت هي الصحيفة الوحيدة في شمال البلاد آنذاك. وذات يوم شد اهتمامي نص شعري مختلف وصفه أستاذي بالرومانسي، وهو لشاعر لم يأخذ حتى ذلك الحين مكانته في عالم الشعر واسمه "عبدالله البردوني". وبقيت أتتبع ما ينشره هذا الشاعر من قصائد وأتوق إلى معرفته، إلى أن تحقق ذلك في صيف 1957م وفي اللقاء الأول حدثته عن إعجابي بقصيدته المشار إليها وقصائد أخرى، وحدثني عن قصيدة لي سبق لي نشرها في الصحيفة نفسها بعنوان "شكوى الغريب".
منذ ذلك الحين انعقدت بيننا صداقة لم تنفك عراها رغم كل ما تخللها من محاولات سخيفة من سياسيين ومنافسين يكرهون كل معنى للصداقة، ولا يصطادون إلاَّ في الماء العكر، وكنا بعد اللقاء بوقت قصير قد شرعنا في إنشاء صحيفة أدبية خطيّة تحمل اسم "الأدب" كان هو رئيس تحريرها وكاتب المقال الرئيسي فيها؛ لكنها كأي محاولة جادة في ظروف الجدب والقمع والشك في دور الكلمة توقفت بعد صدور ثلاثة أعداد منها، وكنا نبعث بها إلى أصدقائنا خارج العاصمة وندعوهم للمشاركة في الكتابة في صفحاتها. كان الصديق عبدالله البردوني –آنذاك- يعيش في كوخه الملحق بمسجد السوق، وكانت المساجد –يومئذ- تضم غرفاً لطلاب العلم، وفي هذا الكوخ التقيت عدداً من هواة الأدب ومن الشعراء الشبان أمثالي الذين أصبحوا فيماً بعد زملائي في العمل.
وفي عام 1958م شاركت في مسابقة أدبية للشباب نظّمتها وزارة التربية والتعليم في مصر على مستوى بعض الأقطار العربية، وكنتُ واحداً من الفائزين في تلك المسابقة، وسافرت إلى القاهرة لأول مرة. وبالقرب من الفندق الذي نزلت فيه، ومكانه في وسط البلد، شدّت اهتمامي لافتة مكتوب عليها "معهد تعليم المكفوفين القراءة والكتابة"، وتذكّرت لحظتها صديقي الحميم، ووجدت نفسي مندفعاً إلى ذلك المعهد الذي كان في الدور الأول من عمارة كبيرة ويتألف من فصلين، أحدهما خاص بالمكفوفين الذكور والآخر بالمكفوفات الإناث. وقد أخذت فكرة سريعة عن المعهد الذي يعتمد طريقة "برايل" المعروفة عالمياً، وبعد حديث قصير مع مدير المعهد أعطاني بعض النماذج الورقية المستخدمة في التعليم ومنها الأبجدية التي يتعرف عليها المكفوف عن طريق اللمس بالأصابع، وبعد عودتي قدمتها لشاعرنا الذي حاول عن طريق اللمس أن يستوعب حروف الأبجدية فلم يتمكن، وقال إن للأبجدية في ذهنه صورة أوضح وأسهل.
وبعد سنوات قليلة سافر عدد من المكفوفين للدراسة في مصر، وحققوا نجاحاً باهراً في استيعاب طريقة "برايل" في القراءة والكتابة، وفي استخدام الوسائل التي كانت قد وجدت في مجال تعليم المكفوفين. وعندما رجعوا إلى البلاد حاولوا مع شاعرنا مرة ثانية وبخبرة تطبيقية عالية، لكنه رفض الاستجابة وأكد أنه يرى بوجدانه ما لا تستطيعه الحواس الخمس، وقال إنه يكتب القصيدة ذات الخمسين والستين بيتاً في صفحة ذاكرته بيتاً بيتاً، ولا يمليها على الكاتب إلاَّ بعد أن تكون قد صارت مرّتبة منتظمة السياق، ولذلك فهو لا يحتاج إلى وسيلة تشوش عليه صفاء ذاكرته أو تغيرّ طريقة تطبيقه للمعرفة، وهي الطريقة التي سار عليها أبرز المثقفين والمفكرين المكفوفين، وفي مقدمتهم طه حسين الذي لا نشك في أنه كان على معرفة بتلك الوسائل المستخدمة في تعليم المكفوفين واعتمادهم على أنفسهم في حالة غياب القارئ أو الكاتب، لكنه لم يستجب لدعاة الأخذ بها، وهو يشبه موقف البردوني الذي كان هناك العشرات ممن كانوا يودون أن يكونوا عين شاعرنا وقلمه في أي وقت وحين.
3- البردوني الثائر:
ما عرفته إلاَّ ثائراً متمرداً ليس في شعره فحسب بل وفي مواقفه، وحتى قصائده الموسومة بالمدحية لم تكن سوى مداخل إلى الحديث عن معاناة الشعب وما كان قد وصل إليه من بؤس فاقع وتخلف فاجع. وكانت البلاد في تلك المرحلة من أواخر الخمسينيات وبدايات الستينيات تمر بحالة من التململ والبحث عن خروج من قبضة التخلف والخضوع للطغيان الفردي والاحتلال الأجنبي، وقد شهدت تلك المرحلة القصيرة أكثر من محاولة للتغيير تم قمعها بعنف، لكنها جميعاً هيأت الأرضية المناسبة لانطلاقة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي بشَّر بها الشعر منذ الأربعينيات، وتمكّنت هذه الثورة - رغم ما قوبلت به من تآمر وحروب -من إثبات وجودها وتحقيق مبدأ الخلاص، باسم الشعب، من كوابيس الاحتلال الأجنبي والحكم الاستبدادي، وقد استقبلها شاعرنا بقصيدة جاء فيها:
ها نحن ثرنا على إذعاننا وعلى
نفوسنا واستثارت أمُّنا "اليمنُ"
لا "البدر" لا الحَسَنُ السّجان يحكمنا
الحكم للشعب لا "بدرٌ" ولا "حَسَنُ"
نحن البلادُ وسكان البلاد وما
فيها لنا، إننا السكانُ والسكنُ
اليومُ للشعب والأمسُ المجيدُ له،
له غدٌ، وله التاريخ.. والزمنُ
فليخسأ الظلم ولتذهب حكومته
ملعونةً، وليولي عهدُها العفنُ.(1)
والإشارة في واحدٍ من هذه الأبيات إلى كل من "البدر" و"الحَسَن" بوصفهما المتنافسين على حكم البلاد بعد الإمام أحمد حميد الدين، وكان لهذا البيت، وللقصائد الوطنية التي رافقت قيام الثورة، دورها الفعّال في خلق ثقافة ثورية نجحت في صد التيارات المعادية المدعومة من قوى التخلف العربي والاحتلال الأجنبي. وفي هذه الفترة عملنا معاً في دار الإذاعة، وفي إعداد برامج مشتركة مع صفوة من زملائنا الاذاعيين الذين كانوا صوت الثورة ولسان حال الشعب، وتضافرت الكلمة مع البندقية في مواجهة حرب فرضتها ضرورة الدفاع عن المستقبل وأحلامه في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية، وستظل أيامها الخالدة محفورة في أزهى صفحات التاريخ المعاصر لهذا الجزء من الوطن العربي الذي كان قد أصبح نسياً منسياً كأنّه لا وجود له على الخريطة العربية وليس له أدنى شأن.
ولعل أخطر قصيدة ثورية بكل ما تجسده الكلمة من معنى هي تلك التي كتبها في فبراير 1948م بعد انكسار الثورة الدستورية، وهي موجهة إلى الإمام أحمد حميد الدين، الحاكم الذي جعل من اغتيال والده ذريعة للاستيلاء على العرش، ويبدو أن القصيدة تعرّضت لبعض الإضافات والمراجعات الفنية، ولم تظهر إلاَّ في ديوان "جوّاب العصور" الصادر عام 1993م، ومنها:
لن ترحم الثوارَ والُهتّافا
هلاَّ رحمت السيفَ والسيّافا
أوما على المقدام يوم النصر أن
يرعى الشجاع، ويرحم الخوّافا
أيكون ما أحرزته نصراً إذا
قاتلت أجبنَ أو قَتلت ضعافا؟
أسمعت عن شرف العداوة، كي ترى
لِخضَمّ تقطيع الرؤوس ضفافا
* * *
سأحثُ أسئلتي إليك، وإنني
أرمي بهنّ وبي إليك جزافا؟
هاك القصيدة والمقصد سلهما
أن تبتغى، أودعهما استخفافا
سأظل أسال "أحمداً" لا "مالكاً"
كيف استطبت بأهلك الإجحافا؟
فدخلت "صنعا" فاتحاً وقطوفها
أشهى إلى من جاءها مصطافا
هل قال قتل أبيك: ترقى بعده
تفنى وتسجن باسمه الآلافا؟
أتركته بالأمس يلقى قتله
كي لا ترى للأمر فيك خلافا؟ (2)
4- البردوني خارج اليمن:
كانت أول رحلة يقوم بها شاعرنا خارج البلاد هي تلك التي دُعي فيها للمشاركة في مهرجان المربد في العراق الخاص بإحياء ذكرى أبي تمام. كنتُ يومئذ في القاهرة أستعد لنيل درجة الماجستير عن الشعر المعاصر في اليمن، وكانت رحلة شاعرنا إلى العراق تمرُّ عبر القاهرة. وقد استقبلته وحاولت أن أكون دليله لمعرفة الأهم من معالم أكبر عاصمة عربية. وبما أن مصر هبة النيل فأول ما يتبادر لزائرها وقفة على نيلها، لذلك كان أول شيء قمت به أن ذهبت وإياه إلى أقرب مكان من هذا النهر العظيم، وأمسكت بيديه وتركته يغسلهما بماء النيل ويتحسس جريان المياه ويصغي إلى صوت انسيابه المتسارع، وبعدها مباشرة ذهبنا في جولة طويلة إلى منطقة الأهرام وتوقفنا طويلاً تجاه الهرم الأكبر وهناك صار يتحسس بيديه حجارته البالغة الضخامة ويستعيد ما قرأه من قصائد أحمد شوقي في هذا الأثر الجليل ويردد أبياتاً من قصيدة "أبي الهول" الذي "طالت عليه العصر"، وهي من أجمل قصائد شوقي.
كان كعادته يقظ الحواس، يرى كل شيء من خلالها، ويتمثل الأشكال والمرائي ويتحدث عنها وكأنه يرى بعنيين نافذتين إلى أعماق الأشياء، وبعد أيام ثلاثة أمضاها في القاهرة اتجه إلى بغداد، ومنها إلى المربد، حيث ألقى قصيدة "أبو تمام وعروبة اليوم"، فكانت قصيدة المهرجان، وبها سجل المشهد الشعري في اليمن أول حضورٍ لافت ومهم بعد سنوات من التجاهل والإهمال.
ومن بغداد عاد إلى القاهرة ليواصل الإقامة بها لأكثر من شهرين عرّفته خلالهما على عدد من الشعراء وأساتذة الجامعة، وفيها أنجز بعض فصول كتابه "رحلة في الشعر اليمني قديمه وحديثه"، وطلب مني تقديمه والإشراف على طباعته. وقد وجد هذا الكتاب صدى واسعاً في الأوساط الأدبية اليمنية كانت تعكس قبول البعض واعتراض آخرين، لكن الكتاب كان بمثابة أول حجر يُلقى في بحيرة الشعر اليمني بعد أن سئمت الركود وملّت الصمت.
وفي ضوء ذلك الإصدار وما تركه من أصداء بدأت المقارنات والمفاضلات، وبدأ النشاط النقدي ينمو ويأخذ أبعاداً جادة وأخرى غاضبة، وثار جدل لم تتبلور معالمه حول كل من الزبيري والبردوني ودورهما الريادي مقارنة بالشامي والحضراني وجرادة ومحمد عبده غانم ولطفي جعفر أمان وعلي محمد لقمان وعلي بن علي صبره وأخرين. وقد اقتحمتُ تلك الموجة من الجدل في محاولة موضوعية لفك الاشتباك بين المتخاصمين، وتوصلت إلى رؤية يتحدد من خلالها موقع الشاعر التاريخي وموقع الشاعر الكبير، ووجدت أن الزبيري يأخذ مكانة الشاعر التاريخي بجدارة، وأن البردوني يتسنم دور الشاعر الكبير بجدارة أيضاً، وليس في هذا التوصيف النقدي خروج عن الموضوعية فقد كان الزبيري بوطنياته وموقفه السياسي شاعراً تاريخياً، كما كان البردوني إضافة كبيرة لم يكن لأي من الشعراء المشار إليهم أن يرتقي إلى مستواه، وليس في هذه الإشارة ما يقلل من أهمية أولئك الشعراء أو ينتقص من دورهم الريادي ومحاولة بعضهم التبشير بالحداثة في محتواها المضموني، أو دورهم في تأكيد أهمية هذا الفن المسمى بالشعر الذي يخرج عن محيط المديح والرثاء ويتناول الشأن العام.
5- البردوني.. المتجدد:
لقد كتبتُ الكثير من الدراسات عن شعر البردوني وقدمت لديوانه "الأعمال الكاملة"، ولكتابه "رحلة في الشعر اليمني"، وكنتُ واحداً من المتابعين للتطوّر المدهش والمثير الذي لحق بشعره في السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته واندفاعه نحو التحديث في اللغة والمضامين، ومحاولته الجريئة في خلخلة "عمودية" القصيدة البيتية دون المساس بشكلها الخارجي والاكتفاء بما يمكن وصفه بتدوير المقاطع وتداخلها، وهو ما يؤكد ما ذهبتْ إليه بعض الدراسات من أنه اتجه لقراءة الشعر الجديد وقصيدة النثر خاصة فوضعته في أجوائها المجازية والاستعارية التي تتحدى المواضعات التقليدية، وتتعامل مع اللغة بحرية مطلقة ومجاوزة لقواعد المجاز القديم. وفي عناوين دواوينه الأخيرة ما يكشف بوضوح أبعاد هذا المجاوزة، مثل: "زمان بلا نوعية"، "وجوه دخانية في مرايا الليل"، "ترجمة رملية لأعراس الغبار"، "كائنات الشوق الآخر"، "رواغ المصابيح". والعناوين وحدها تكشف عن التحول الكبير في التعامل مع اللغة والانتقال من المباشر إلى المتخيّل. وقد وضع هذا التحديث أنصار القصيدة التقليدية في حيرة بالغة، وصار بعضهم يردد علناً: هذا ليس البردوني الذي نعرفه!
لقد توقف هؤلاء عند مستوى معين من الكتابة الشعرية، وتجمّدت أذواقهم عند مراحل معينة ولم يدركوا أهمية التغيير ولم يظهروا شيئاً من الاستجابة لنداء العصر ومؤثراته، في حين أدرك شاعرنا خطورة الوقوف عند مستوى معين مهما تحقق له عنده من شهرة ومعجبين ومقلدين.
وفي صلة بهذا الموضوع تجدر الإشارة إلى أن الموقف القديم لشاعرنا لم يكن يختلف عن موقف أي شاعر من شعراء القصيدة الكلاسيكية، فقد كان يُناصب قصيدة التفعيلة العداء، ولا يكف عن السخرية بكل محاولة شعرية تخرج عن إطار "البيتية" المحافظة، بما في ذلك التجديد المحدود الذي كان قد بدأ به شعراء المهجر في كتابة قصائدهم على نهجه كالمقطَّعات متنوعة القوافي. وعندما بدأتُ كتابة بعض محاولاتي الأولى بنظام التفعيلة لم يتردد في تخطئتي واعتبار ما أقوم به، وشعراء التفعيلة بعامة، تخريباً للشعر العربي وتدميراً لشكله المتعارف عليه الذي استوعب طاقات التعبير عبر العصور، وكان يذكرني بمحاولاتي العمودية التي تنتمي من وجهة نظره إلى الشعر الحقيقي، وطالما استشهد ببيتين لي من قصيدة نشرتها فيما بعد في ديوان "لابد من صنعاء" والبيتان هما:
والآن يا موتُ ألا تقترب من جسدٍ فوق الثرى فاني
يسيرُ بين الناسِ مستخفياً كطيف إثمٍ بين رهبانِ. (3)
وأتذكر حديثاً له مع مجلة لبنانية كان فيه حاداً شديد السخرية بكل شعر يخالف النمط الموروث والمألوف؛ لكنه بعد أن أطال التأمل وقراءة الجديد الشعري تراجع عن كل آرائه المعادية للجديد، وانصرف – كما كان يقول- عن قراءة الشعر العمودي قديمه وحديثه وصار منكبّاً على قراءة الجديد والأجد، وكانت لغة قصيدة النثر تستهويه وتشغله وتفتح أمامه آفاقاً من الصور والتعابير الأقرب إلى السوريالية التي نجدها في الكثير من قصائده في دواوينه الأخيرة، ومنها على سبيل المثال من ديوان "رواغ المصابيح":
يرى الثواني من قفاها كما
يستقرئ الملهى جيوب الزبون
له يد تندى وأخرى كما
يخيف وحشٌ صبيةً يلعبون
يبدو سكونياً ولكن له
تحركٌ لا يبتدي من سكون. (4)
ومن ديوان "زمان بلا نوعية":
ليس بيني وبين شيء قرابة
عالمي غربة، زماني غرابة
ربما جئت قبل أو بعد وقتي
أو أتت عنه فترة بالنيابة
غيّرت وقتها الفصول، وضاعت
أعين الشمس والنجوم الثقابة
منتهى الصحو سكرة سوف تصحو
من ترنيّ، ومن تغني "حبابه"
* * *
جاء من يسبحون في غير ماء
وعلى الماء يزرعون الكتابة
يا زمانا من غير نوع تساوت
مهنة الموت واحتراف الطِّبابة
ينمحي الفرق بين عكسٍ وعكسٍ
حين ينسى وجه الصواب الإصابة. (5)
ومن ديوان: "ترجمة رملية.. لأعراس الغبار" نص بعنوان "صعلوك من هذا العصر"، ومنه:
كان يحس أنه خرابه
وأن كل كائنٍ ذبابة
وأن في جبينه غراباً
يشوي على أنفاسه غرابة
وأنه نقابة طموحٌ
وشرطهٌ تسطو على النقابه
وبعضه يلهو بهجو بعضٍ
وكله يستثقل الدعابة. (6)
وفي الديوان نفسه نص آخر بعنوان "زمكية" يحل فيه المكان محل الزمان والعكس، ويتقدم فيه الغد على اليوم، والأمس على الغد، وهو ما تسعى إليه السوريالية من تحقيق المحال من خلال اللغة، وهو ما يذكرنا بتعريف "سيبويه" من أن المحال "أن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غداً وسآتيك أمس":
المكان الآن، والآن المكان
والذي كان غداً بالأمس كان
والذي يأتي، أتى مستقبلاً
قبل أن يزَّوَّج السوق الأوان
قبل أن تتلو الشظايا عهدها
قبل أن يستبق الرمح الطعان
ألغتْ الأفعال فعليَّاتِها
شكلت أسماؤها عنها لجان. (7)
لقد حافظ البردوني على الشكل التراثي المألوف لكنه نجح في أن يملأه بما ليس تراثياً ولا مألوفاً من التعابير الشعرية المدهشة، والقادرة على إثبات أن لكل عصر لغة تعبير تختلف في استعاراتها ومجازاتها وانزياحاتها عن لغة أي عصر آخر، كما كانت لغة الشعراء الأمويين، تختلف عن لغة شعراء ما قبل الإسلام، ولغة الشعراء العباسيين تختلف عن لغة الشعراء الأمويين. وبذلك يستمر التصاعد في الإبداع والتجدد في رحلة الحياة. وهكذا تبدو تجربته الشعرية النوعية المتجددة وكأنها ترسم للأجيال طريقاً يقاوم التعصب والتحجر، ويدعو إلى الانطلاق خارج ما كانت التقاليد قد صاغته من قواعد جامدة ونصائح تدعو إلى العزلة والانكفاء.
6- البردوني والمدينة:
زار البردوني مدناً عربية كثيرة لكنه، كما حدثني، لم يجد نفسه سوى في ثلاث مدن هي التي أثَّرت في حياته كما في شعره، مدينتان يمنيتان هما صنعاء وعدن، والأخرى عربية هي دمشق، وكانت الأخيرة قريبة من بيروت حاضرة الثقافة العربية الحديثة، لكنه-وقد عاش في دمشق شهوراً- لم يفكر في زيارتها أو يشير إليها من قريب أو بعيد سواء في كتاباته الشعرية أو النثرية، رغم أنه اغترف –في وقت مبكر – من معين أبداعها النثري والشعري. ذلك لأن المدن كانت بالنسبة إليه هي الناس لا الطبيعة، ولا ما تتميز به من أماكن سياحية ومناظر خلابة. وقد وجد في دمشق حالة من الألفة الوجدانية والتواصل الحميم مع البشر، وفيها تمكن من طباعة كل دواوينه وكتبه وأعاد طبعها ووجد فيها، بوصفها مدينة عربية مضيافة، مناخاً يساعد على الاستقرار والشعور بالطمأنينة التي يفتقدها في مدن أخرى باستثناء صنعاء وعدن.
وقد أتاحت له المهرجانات الأدبية زيارة عدد من المدن العربية منها الكويت والرياض وجدة وأبو ظبي والمنامة، ومدن عربية أخرى، لكنها لم تترك في ذاكرته مساحة من الفضاء الشعري يستحق التأمل، فقد كان –كما سبقت الاشارة– مشغولاً بالناس لا بالمكان، وهذه الملاحظة قد تستدعي دراسة للبحث في المكان في شعره، وهو مكان تاريخي أو متخيل. أما صنعاء فقد حظيت من شعره بأهم قصيدة تجلى فيها شغفه بها، كتبها وهو مقيم في دمشق بعنوان "صنعاء.. في فندق أموي" ،وفيها يتحدث عن شوقه إليها وقلقه عليها، وإحساسه بأنها معه تشاركه أسفاره وتأكل من أكله وتشرب من شرابه:
طلبت فطور اثنين: قالوا بأنني
وحيد.. فقلت اثنين إن معي "صنعا"
أَكلتُ وإِياها –رغيفاً ونشرة
هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعى
وكانت لألحاظ الزوايا غرابةٌ
وكانت تديرُ السقف إغماءةٌ صلعا. (8)
7- البردوني في سيرته الذاتية:
تستأثر السيرة الذاتية في حياة كثير من المشاهير المبدعين بجزء كبير من الاهتمام. وكان شاعرنا قبل رحيله بعام واحد تقريباً قد فاجأ قُرّاءه بسلسلة من المقالات الأسبوعية يتحدث فيها عن سيرته الذاتية، وهي خطوة تأخرت كثيراً، وجاءت بعض فصولها كأنها استدراك لشيء كان ينبغي أن يصدر في وقت مبكر والذاكرة في ريعان نشاطها وعمق قدرتها على التذكر والإحاطة بالتفاصيل الدقيقة. وكنا تحدثنا طويلاً عن طه حسين وأيامه التي كتبها في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين وهو في أوج نشاطه الأدبي والفكري، وذاكرته في أزهى حالاتها قادرة على التقاط الأحداث وتمثل انفعالاتها. وكان البردوني يبدي امتعاضه يومئذ عندما يطلب إليه أحدهم كتابة سيرة حياته، ويرى أن سيرته ماثلة في شعره، وهو الموقف الذي اتخذه عدد من الشعراء والمبدعين العرب حول الانشغال بكتابة السيرة الذاتية التي سبق لهم أن عبروا عنها في قصائدهم، وماذا كان سيقول المتنبي مثلاً في سيرة نثرية يكتبها بعد أن اتسع لها شعره وعبرّ عنها أصدق تعبير!
وبما أن الحديث عن سيرة شاعرنا، وهي لفته مهمة وإن جاءت متأخرة، فتجدر الإشارة إلى أجمل عبارة قيلت في هذا الصدد، وهي تلك التي قالها الشاعر الكبير محمود درويش في واحدة من أهم مقابلاته حيث قال "أسراري في نصوصي"(9)، مضيفاً إلى تلك العبارة قوله أيضاً إن سيرته العاطفية والعامة مكتوبة في شعره، وهذا لا يعني أن على الشعراء –والكبار منهم خاصة- أن يقلعوا عن كتابة سيرهم الذاتية، بقدر ما عليهم أن يتحرّوا الدقة في رواية ما يحسبونه جزءاً من حياتهم التي لا تخلو من ارتباط بالآخرين ممن عايشوهم وشاركوهم في بعض فصول من تلك السيرة، وهو ما يدفع بكثير من الشعراء إلى تجنب كتابة سيرهم إذا كانت ستلامس من قريب أو بعيد هذا الطرف أو ذاك بما يتنافى مع أدب السيرة، وكونها عملاً إبداعياً إضافياً إلى أعمال المبدع الشعرية والنقدية.
------------------------
* دراسة ضمن كتاب "عبد الله البردوني الشاعر البصير، دراسات وأبحاث"، سلسلة الندوات (21)، مؤسسة العويس الثقافية، 2019.
-------------هوامش--------:
1- البردوني: في طريق الفجر، صــــ269، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، بلا تاريخ.
2- البردوني: جواب العصور، صــ170، دار الحداثة، بيروت 1993م.
3- المقالح: لابد من صنعاء، صـــ 649، دار الهناء، القاهرة 1971م.
4- البردوني: رواغ المصابيح، صـــ21، مطبعة الكاتب العربي، دمشق 1989.
5- البردوني: زمان بلا نوعية، صــ77، مطبعة العلم، دمشق 1979م.
6- البردوني: ترجمة رملية.. لأعراس الغبار، صـــ149، دار الفكر، دمشق 1997م.
7- البردوني: نفسه، صـــ230.
8- البردوني: زمان بلا نوعية، صـــ13.
9- مجلة دبي الثقافية: العدد (1) أكتوبر 2004م، صــ28.
•من صفحة الدكتور المقالح على الفيسبوك