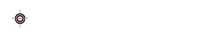منذ 3 سنوات
منذ 3 سنوات
العدالة والقانون... وما بينهما!
منذ 3 سنوات
كنت، ولعلي لا أزال، مولعًا بفكرة العدالة. لم تنجح مذابح الشموليات والشعبويات التي قدمت تطبيقًا دمويًّا للعدالة، ولا بشاعات البوليس السري خلف الستار الحديدي في هز إيماني بأهميتها. لكن مفهومي للعدالة بعيد جدًّا عن عدالة القمع وقولبة الناس في قوالب حديدية.
وكنت، ولعلي لا أزال، أرفض ذلك التعارض بين العدالة والحرية، الذي اصطنعته الأيديولوجيات الشمولية والأديان الشمولية. فالعدالة والحرية توْءَمان لا ينفصلان، والحرية شرط مسبق للعدالة، وليس نتيجة لاحقة لها.
والعدالة عندي لا تعني المساواة الحرفية. فلا يهمني كون ثروة بيل غيتس 80 مليارًا، مقابل كون دخل فلان بضعة آلاف في الأسبوع ما دامت هذه الآلاف تكفيه لحياة كريمة يتمتع فيها وعائلته بصحة جيدة وغذاء كافٍ وتعليم جيد وتوفير مقبول لنهاية العمر. لا أطمع في مليارات الأغنياء؛ لأن مصادرتها لن تحقق العدالة، بل أطمع في تحقيق حلم الدخل الأساسي العالمي Global basic income الذي بموجبه يحظى كل شخص على هذه الأرض بالحد الأدنى من المال غير المشروط الكافي لتلبية احتياجاته الأساسية حتى ولو لم يكن يعمل.
ولا علاقة للعدالة عندي بـ"اشتراكية الحمقى"، تلك الاشتراكية التي لا تحب الفقراء ولكنها تكره الأغنياء، ولا تريد إلغاء الفقر، بل تسعى لتعميمه بين الناس. كانت فنزويلا، على سبيل المثال، مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها، ثم جاء شافيز وأغلق المصانع باسم محاربة الإمبريالية، وحوّلها إلى معتقلات وسجون. وما أبعد تصوري للعدالة عن جنون الفقر وهستيريا كراهية الإنتاج والمال والوفرة.
لكن قضية العدالة معقدة جدًّا، وقد يكون الأدب المنفذ الوحيد لشرح تعقيداتها في حال عجز الفلسفة والاقتصاد.
فإذا شئت أن ألقي عليك بعضًا من شجون حديث العدالة فسأحكيها لك كما تجلت في مسرحية للمسرحي ألفريد فرج أحد رموز المسرح المصري في عصره الذهبي، وهي مسرحية "رسائل قاضي إشبيلية".
يستقيل قاضي إشبيلية من منصب قاضي القضاة بسبب كبر سنه، ويطلب منه الأمير أن يكتب له عن أغرب القضايا التي طرحت عليه. لكن القاضي يصدم أسماعنا قبل أن يحكي حكاياته بإقراره لمبدأ غريب وغير متوقع، يقول قاضي إشبيلية في المسرحية:
"القاضي -أبقاك الله- لا يشتغل بإقامة العدل بين الناس ولا هذه وظيفته، كما يذهب بك الوهم عادة. إنما وظيفة القاضي الحكم بين الناس بالقانون. والقانون قد لا ينطبق على العدل، والعدل قد لا يطابق القانون"!
هل استغربت كما استغربت أنا بهذه التفرقة بين العدل والقانون؟ لطالما وحدنا بينهما، واعتبرناهما كتلة واحدة أو ذرة واحدة لا تنشطر، فإذا انشطرت هزت المجتمع انفجارات مهولة من الظلم والطغيان والفوضى.
لكن ما أبسطها من حقيقة. فالقانون لا يحقق العدل بالضرورة. فكم من قوانين صاغها الطغاة لتزيدهم طغيانًا، وكم من تشريعات أصدرها الظالمون لتزيد من قدرتهم على ظلم المظلوم.
أرأيت لو أن مدرسًا من جملة آلاف المدرسين، الذين انقطعت رواتبهم منذ ثلاث سنوات، سرق رغيف خبز لإطعام عائلته، ثم تم القبض عليه وعرضت قضيته أمام القاضي. فهل سيحكم عليه القاضي بالعدل أم بالقانون؟
إن القاضي مجبر أن يحكم بالقانون، والقانون صريح في عقوبة السرقة وشروطها. وقد يكون القاضي رحيمًا فيطبق "روح القانون"، بدلًا من نصه ويخفف العقوبة إلى النصف أو الربع، إلا أنه في الأخير سيحكم بالقانون، لكنه لن يحقق العدل ولن ينصف المدرس المظلوم. ولو أراد القاضي الإنصاف لكان عليه استدعاء السلطات الحاكمة التي توقفت عن دفع مرتبات الموظفين لأكثر من أربع سنوات، وتنعمت بأموال الجبايات والمساعدات حتى انتفخت بطونها وأوداجها وعجائزها.
أعرف الفكرة التي قفزت إلى عقلك من بين السطور. وأعرف أنك ستقول إن على القاضي تجاوز القانون والحكم بالعدل وتحدي السلطة لو لزم الأمر. ألا تحدثنا كتب التاريخ عن قضاة تحدّوا الحكام وأنفذوا سلطة القانون رغم عدم رضا الحاكم؟
لكنني أقول لك، إن هذا القاضي الذي تحدى السلطان لم يطبق العدل بل طبق القانون؛ لأن تطبيق العدل كان يقتضي منه أن يتمرد على السلطان ويطالب بخلعه، وفي هذه الحالة سيتحول من قاضٍ إلى متمرد، وسيصبح القاضي الموكل بإنفاذ القانون ضحية للقانون وللعدل معًا.
أما قاضي إشبيلية كما صورته مسرحية ألفريد فرج، فيقول للأمير:
"لكي تدرك الفيصل بين القانون وبين العدل، اجلس للقضاء وبين يديك فئة خارجة على السلطان. فإن أنت حكمت بالقانون فلا بد أن تهزم الفئة الخارجة، وإن أنت احتكمت إلى العدل، فلا بد أن تعرف معرفة اليقين الفارق بين النهضة والفتنة. فأنبياء الله خرجوا ثلاثتهم على سلاطينهم وأحدثوا النهضة، كما أن كل فئة شريرة قد خرجت على سلطانها أحدثت فتنة، فعليك بالفحص، ولكن لو ذهب القاضي إلى فحص نية الخروج وغرضه وجوهره، فقد أسقط ولاءه للسلطان وسقطت مِن ثَمّ ولايته على القضية وبطل كل حكم يصدره، حيث إن قوة نفاذ الحكم لا تستند إلا إلى السلطان".
إن القانون هو محصلة التوازن بين القوة والمصلحة، قوة السلطة ومصلحة الناس، أما العدالة فهي محصلة الإنصاف التي لا تلقي بالًا للقوة، وفي حالة الاستبداد لا يقوم العدل إلا لو سقطت السلطة. لكن سقوط السلطة يعني سقوط القانون أيضًا، وبحث الناس عن تطبيق العدل دون قوة ناظمة، وبالتالي وقوعهم في الفوضى والخراب. ألم يكن خطؤنا وخطأ الربيع العربي في 2011 وما بعدها، أننا أردنا تحقيق العدل وإسقاط القانون، فخسرنا الاثنين معًا؟
يقول قاضي إشبيلية للأمير: "القانون -عافاك الله- جوهره المنفعة والمصلحة التي لا تتحقق إلا بالقوة. فمن لا قوة له، لا قانون له... أما العدل فمعصوب العينين، لا يميز بين قوة المصلحة ومصلحة القوة. بينما القانون مفتوح العينين يقوم على الموازنة بين عناصر القوة، والقانون هو محصلة هذه القوى وميزانها".
دعني أختم تساؤلاتي بهذه القصة الحقيقية.
قبل أسابيع، تناقلت المواقع خبر بياع فقير، صاحب بسطة على الشارع، قتل أربعة من موظفي البلدية في مدينته.
أمام حادثة كهذه نحن أمام طريقين: طريق العدالة، وطريق القانون.
طريق العدالة سيبحث عن الأسباب التي من أجلها ارتكب البياع الفقير هذه الجريمة. سيكتشف طريق العدالة جرائم لا تنتهي من الجبايات التي تفرضها السلطة على الفقراء. سيصعد طريق العدالة أكثر ليكتشف نظامًا خفيًّا للإرهاب والنهب والجبايات يسحب الريالات القليلة من جيب الفقير ليحولها إلى مليارات في جيوب ضباع السلطة الخفية.
سيجد طريق العدالة نفسه أمام جريمتين؛ جريمة صغيرة هي قتل موظفين رسميين، وجريمة كبرى هي ابتزاز شعب بأكمله وتجويعه. وستعاقب العدالة على الجريمتين! لكن طريق العدالة غير موجود في واقع المجتمعات الخاضعة للاستبداد والقهر.
ليس أمام القاضي إلا طريق واحد هو طريق القانون، القانون مهم، لكنه مملوك للسلطة، والسلطة لا تعاقب إلا على الجرائم الصغرى؛ لأن الجرائم الكبرى هي سلوكها اليومي.
نقلا من صفحة الكاتب بالفيس بوك