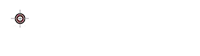لمن الحكم اليوم؟
مشكلة مشروعية الحكم في تاريخ المسلمين قديمة، وهي ـ غالباً مشروعية دينية ـ مرتبطة بالخلافات المذهبية، بل إنها ربما كانت السبب الرئيسي وراء تلك الخلافات.
فقهاء السنة أكدوا على أن «الخلافة في قريش» في نظرة قبلية للمعايير التي على أساسها تكون مشروعية الحاكم، فيما قال الشيعة إنها في «أهل البيت» كجزء من العلويين الذين هم جزء من قريش، في تكريس واضح لسلالية المعايير التي على أساسها تكون مشروعية الحاكم، غير أن هاتين المقولتين كانتا مجرد إفراز للسياقات التاريخية والمجتمعية والثقافية التي لا علاقة لها بالأبعاد العقدية في الإسلام.
ومع تغلب الأمويين، على أبناء عمومتهم من العلويين تغلبت فكرة «قرشية الخلافة» على «علوية الإمامة» حيث كان الأمويون مهتمين بعدم حصر السلطة في العلويين، وأن تكون في قريش عامة، وذلك لإيجاد مرجعية دينية لسلطتهم كجزء من قريش، بعد خروج العلويين من السلطة الذي أدى إلى دخولهم مع الفرس في «تحالف المهزومين الفارهاشمي» الذي قضى على دولة بني أمية، مع قدوم جيوش العباسيين التي قادها القائد الفارسي أبو مسلم الخراساني، تحت شعار «الرضا من آل محمد» بعد أن زعم العباسيون أن ثورتهم هي من أجل تسليم السلطة للعلويين.
وبما أن السلطة، لا تعرف صديقاً ولا قريباً، فإن العباسيين الذين أسقطوا حكم الأمويين في المشرق الإسلامي باسم الدعوة لـ«أهل البيت» من ذرية علي، قاموا بأكبر مجزرة ضد أبناء عمومتهم من العلويين على يد الخليفة أبي العباس عبدالله بن محمد بن علي، الذي لقب بـ«السفاح» لكثرة ما قتل من العلويين الذين ثار العباسيون باسمهم، لتتوارى مقولة «إمامة العلويين» مجدداً، وتستمر فكرة «قرشية الخلافة» وإن بشكل أقل بروزاً مما كانت عليه في العهد الأموي.
وخلال العصر العباسي الثاني بدأ ضعف «الخلافة العباسية» وتحكم بالخلفاء وزراء من غير قريش ومن غير العرب، ثم أصبحت «الخلافة» تحت حماية أو رحمة دول أخرى إسلامية غير قرشية وغير عربية من الأساس، وأصبح حكم الخليفة صورياً، فيما السلطة الفعلية بيد الوزراء وقادة الجيش من البويهيين الفرس الشيعة، ثم السلاجقة الترك السنة وغيرهم، وهو الأمر الذي أدى إلى مراجعات لمسألة «قرشية الخلافة» التي لا تتفق مع تحولات الوضع سياسياً وعسكرياً داخل منظومة الدولة العباسية التي لم يكن للخليفة فيها ـ في بعض الأحيان ـ من أمر سوى سلطة صورية.
وفوق هذا نشأت إمارات ودول إسلامية غير عربية وأخرى عربية غير قرشية، الأمر الذي جعل فكرة حصر الخلافة أو الإمامة في قريش أو في العلويين، غير واقعية وغير منطقية، ليدرك الكثير من الفقهاء وعلى رأسهم «إمام الحرمين» عبد الملك الجويني في كتابه «الغياثي» ضرورة إعادة النظر في تلك المقولات في الفقه السياسي الإسلامي.
وبالنظر إلى السياقات التاريخية لتلك المقولات يمكن الاستنتاج بسهولة أنها مقولات سياسية لا فقهية، وأنها كانت إفرازاً للمتغيرات الواقعية، وأنها ليست من أصول الدين، بل من مقتضيات السياسية.
فالقاضي علي بن محمد الماوردي صاحب «الأحكام السلطانية» كان متمسكاً بفكرة «قرشية الخلافة» وذلك لكي يحمي منصب خلافة العباسيين العرب «السنة» من طموح سلاطين بني بويه الفرس الشيعة، حيث إن استمرار الاعتقاد بشرط القرشية في الخلافة شكل مانعاً دينياً قوياً من سيطرة البويهيين الفرس الشيعة على الخلافة العربية السنية في بغداد.
وعندما ضعفت دولة البويهيين الفرس الشيعة وأصبحت السيطرة على الخلافة العباسية للسلاجقة الأتراك السنة ضعف توجه «قرشية الخلافة» بعد أن آلت السلطة الفعلية على الخلافة العباسية إلى السنة من الأتراك السلاجقة الذين لم يشكلوا خطراً على التوجهات المذهبية للدولة، الأمر الذي أسقط بموجبه الإمام الجويني شرط قرشية الخلافة، بما أن السلطان الجديد الحامي لمؤسسة الخلافة أصبح تركياً سنياً، وإن لم يكن عربياً من قريش، واستمر نهج التخلي عن «قرشية الخلافة» عند القاضي أبي بكر الباقلاني، الذي قال ابن خلدون إنه تركها لما أصبحت «عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم…فأسقط شرط القرشية».
ولاحقاً، تم تجاوز قرشية الخلافة بشكل عملي ونظري بعد انتصار الأتراك العثمانيين على المماليك والسيطرة على مصر، وتنازل آخر الخلفاء العباسيين محمد الثالث المتوكل على الله عن الخلافة للسلطان العثماني سليم الأول، ومنذ ذلك التاريخ أصبح كل سلطان عثماني يحمل لقب «أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين» لتتوارى مسألة قرشية الإمامة في بطون كتب الفقه السياسي التقليدي، بعد أن وصل إلى منصب الخلافة غير قرشي وغير عربي.
ومع مرور الوقت أصبحت قضية «قرشية الخلافة» شيئاً من التاريخ، ولكنها لم تصبح جزءاً من التاريخ إلا بعد أن أدت هزيمتها لفكرة «علوية الإمامة» إلى تضخم الأخيرة – نظرياً – كردة فعل لمعاناتها من عقدة الاضطهاد التاريخي، الأمر الذي جعل العلويين يرفعون إمامتهم إلى مستوى العقائد التي يكفُر كل من لم يؤمن بها، ومن هنا أصبح الإيمان بالإمامة لدى معظم فرق الشيعة كالإيمان بالله، ومالت كثير من فرق التشيع إلى نوع من التماهي بين الذات الإلهية و«الذات العلوية» بعد أن رُفع علي بن أبي طالب إلى مستوى إلهي، وقيل إن «الله حل فيه» وغير ذلك من المرويات الشيعية التي تعد ردة فعل لقرون من إقصاء العلويين من الحكم، الأمر الذي أدى إلى «تضخم ذاتي» لإحداث نوع من التوازن السيكولوجي لتعويض خسارة الواقع، وهي مرويات اخترعت لدعم الفكرة الثيوقراطية في «اصطفاء علي» لإمامة المسلمين، مع العلم أن القول بالاصطفاء ليس منهج علي نفسه، ولكنه من أقوال متأخري الشيعة، وذلك للتأسيس لمشروعية سلطة الذين حاولوا ولا زالوا يحاولون تحقيق مكاسب سياسية باسم الإمام، على اعتبار أنهم ورثته وورثة النبي على أسس جينية سلالية، لا دينية رسالية.
واليوم، وبعد كل ذلك الحراك التاريخي والسياسي الذي أدى إلى حراك فقهي وفكري، لا يبدو أن مقولات مثل «قرشية الخلافة» السنية، و«علوية الإمامة» الشيعية تصمد أمام واقع متحرك يتطلب ترك كل تلك المقولات، والخروج منها إلى وضع الخلافة والإمامة في الشعب، الذي يتولى السلطة عبر ممثليه المنتخبين، لا أولئك الذين تم الزعم بأنهم مختارون من الله.
إن «قرشية الخلافة» تتنافى مع حقيقة أن أطول نظام خلافة إسلامي لم يكن قرشياً ولا عربياً، بل كان عثمانياً تركياً، كما أن «علوية الإمامة» تتنافى مع حقيقة أن الإمامة العلوية مجرد فكرة يوتوبياوية لم تتجسد تاريخياً بأبعادها النظرية المثالية، حتى في عهد الإمام علي بن أبي طالب نفسه.
والخلاصة: يتحتم على المسلمين اليوم الخروج من ربقة تلك المقولات العرفية التي جرى تقنينها في الفقه السياسي، دون أن يكون لها أي مسوغ سوى أنها كانت مرتبطة بعصبويات معينة تجاوزها التاريخ، فلم تعد قريش هي الأقدر على تدبير شؤون الحكم، ولم يثبت أن العلويين سجلوا نجاحاً تاريخياً كبيراً في التاريخ السياسي للإسلام، بل كان هذا النجاح من نصيب الأمويين والعباسيين.
إن الاتفاق على الاحتكام لصناديق الاقتراع وبرامج العمل السياسية سيؤدي إلى تلاشي الاحتقانات الطائفية التي يغذيها الساسة للوصول إلى السلطة، وحينها ستبقى الاختلافات المذهبية حبيسة مستوياتها الفقهية، لكنها ستفقد أبعادها السياسية التي فجرت الحروب والصراعات بين السنة والشيعة قديماً، والتي لا تزال تغذي تلك الصراعات السياسية التي تبدو على شكل حروب طائفية بين الطرفين.