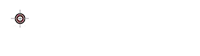جائحة «التفكير السيئ»: من أين تأتي القناعات الفاسدة؟
لعل جولة سريعة للبحث في عقلانية المحتوى المتداول على الصحف والمواقع الإعلامية وأدوات التواصل الاجتماعي ستشير حتماً إلى أزمة معرفية شاملة مما يسميه الفلاسفة بـ«التفكير السيئ» – أي غياب الحجة وراء الادعاءات ورفض الأدلة لدى توفرها - لا تمس أفكار الناس العاديين وتعاطيهم مع العالم والأحداث من حولهم فحسب، وإنما تتغشى أيضاً طروحات المتعلمين والمثقفين على مسرح اليوم، الذين هم بشكل أو آخر نخبة عالمنا وقادته الفكريون. فهناك أعداد هائلة من البشر لم يشهدها التاريخ من قبل تتوزع أركان العالم من غربه إلى شرقه تعتنق أفكاراً غرائبية لتفسير تحولات الأزمنة، أو تتبنى طروحات فاسدة المنطق لتبرر عنصريات مقيتة – عرقية وطائفية وجندرية وحتى طبقية - ضد الآخر المختلف، أو تقضي أعمارها مسجونة في كهوف فكرية مغلقة لا ترغب في مغادرتها. والمقلق أن التكنولوجيا الحديثة التي لا شك فتحت النوافذ لفضاءات معرفية لم تكن لتتوفر لمعظم البشر قبل عقود قليلة، ساهمت كذلك في توسيع دوائر الخلل الأبستمولوجي تلك، وأوصلت شعوذات ورغائبيات، كان سوقها لقرون محلياً، إلى جمهور معولم عابر للحدود واللغات والأديان.
جائحة «التفكير السيئ» هذه - إن جاز التعبير - لا ترتبط حصراً بأذهان أصحابها كنشاط ذاتي محض يقتصر تأثيره عليهم، وإنما تنتشر كما العدوى، وقد تتسبب في دفع المصابين بها إلى ارتكاب اعتداءات وجرائم لفظية وجسدية ضد الآخرين، تصل أحياناً إلى درجة القتل. وتكتمل الكارثة عندما نجد أن كثيراً من تلك الأفكار السيئة عصية على الموت، فمهما تم نقضها أو دحضها أو تكذيبها تظل هائمة في سياقاتنا المعرفية كما (الزومبيات)، وفق توصيف بول كروجمان المفكر الأميركي الحائز على نوبل (الاقتصاد) لها، وأنها غالباً ما تكون في غير مصلحة من يتبناها كمرجعية لمعتقداته وسلوكه.
ولا تبدو «الأفكار السيئة» مرتبطة بشكل منهجي بتدن في المستوى التعليمي أو محدودية الذكاء الفطري أو غياب المعرفة والتي بمجموعها قد تكون سبباً لغياب الدربة على التفكير السليم في حالات معينة وتمنح أصحابها مبرراً مقبولاً أقله على المستوى الأخلاقي لوقوعهم في الزلل. إذ ينتشر عادة التفكير السيئ بين المتعلمين والمتخصصين والمثقفين، الذين بحكم قدرتهم على البحث عن الحقائق وراء الظلال يمكنهم بشكل إرادي مقاومة الوقوع في فخ الأفكار السيئة، لكنهم - ولأسباب متفاوتة - قد يقعون ضحية الكسل الفكري، ويمتنعون عن بذل الجهد لتمييز تلك الأفكار الخطرة من غيرها، ويجدون أنه من الأسهل الاستمرار باجترار معتقداتهم القديمة - وإن بليت - والإبقاء على الأوضاع القائمة كما هي دون امتلاك جرأة التغيير.
ويربط متخصصون ذلك الكسل الفكري بما يسمونها ظاهرة «العناد المعرفي»، أي ذلك التمسك غير العقلاني بمعتقدات توفرت أدلة متقاطعة على بطلانها. وعلى الأغلب أن المعاندين معرفياً ليسوا بالضرورة أشخاصاً سيئين، وإنما هم يتبعون العرف السائد في محيطهم دون إعمال عقولهم لتقييم ما يعرض عليهم من أفكار، أو هم يرون مصلحة ذاتية مؤقتة من وراء تلك المعتقدات. وهذه على نحو ما أخبار جيدة لأنها تشير إلى أن «التفكير السيئ» ليس قدراً، وأنه يمكن عملياً تجنب التورط في أحابيله، ولكنها في ذات الوقت تفتح باب اللوم الأخلاقي – وربما المسؤولية القانونية – لمن يمتنع عن التدقيق في معلومات معينة ويكتفي بتصديق ما يعرض عليه دون أدلة كافية أو يرفض القبول بأدلة مناقضة، لا سيما إذا تسبب هذا «العناد المعرفي» في النهاية بضرر لآخرين.
مهمة التخلص من «الأفكار السيئة» أصبحت بفضل التقدم العلمي والفلسفي المتراكم منذ عصر النهضة مسألة غير معقدة وقريبة إلى كل متعلم، حيث المنهج القائم على تدعيم كل ادعاء نظري بأدلة تجريبية أو منطقية أو كنسه خارج حرم المعرفة. لكن الإنسان العادي في عصر الرأسمالية المتأخر هذا يواجه معيقات جمة تدفعه فرادى أو سوية لتقبل الأفكار السيئة، وتجنب بذل الجهد في البحث عن أدلة تنقضها.
ولعل أخطر تلك المعيقات دور التضليل ونشر الأخبار الكاذبة وأنصاف الحقائق الذي قبلت مؤسسات الإعلام الجماهيري الكبرى القيام به لمصلحة النخب السياسية المهيمنة، لا سيما في الدول المؤثرة على ثقافة المتلقين على نطاق عالمي. وهذه بحملاتها المكثفة وتقاطعها على تعميم التصورات الفاسدة أو المنحازة بشأن ما يجري في العالم تُوقع كثيرين من ذوي النيات الطيبة المنشغلين بأمور معاشهم اليومي في شباك «الأفكار السيئة»، الذين بفضل التعزيز اليومي المستمر لتلك الأفكار في غالب وسائل الإعلام قد لا يدركون الخلل الذي يستندون إليه في تحديد توجهاتهم بشأن مسارات الأحداث.
وتوازي سطوة الإعلام الموجه تلك، منظومة التعليم التي تنازلت عن غايتها النبيلة في نشر التنوير وتعميم المعارف وتسليم الأجيال الجديدة أدوات النقد والتفكير السليم، وانخرطت بدورها في خدمة مصالح الطبقات المهيمنة عبر الاكتفاء بإنتاج كمي هائل من المستهلكين والعمال اللازمين لإدارة عجلة الاقتصاد الكلي دون تزويدهم بالمهارات العلمية والفلسفية اللازمة لطرد «الأفكار السيئة» من الفضاء العام.
وتكتمل حلقة المعيقات الجهنمية التي تحجز الفكر السليم باستقالة الفلسفة – كنطاق معرفي أكاديمي – من موقعها كخط دفاع أخير للمجتمع تعجز «الأفكار السيئة» عن اختراقه، بعدما اختار الفلاسفة المعاصرون لعب دور العرافين والمشعوذين للنخب الحاكمة، يبررون لهم تجاوزاتهم، ويجملون سياساتهم، ويهاجمون بلا هوادة كل من يختار طرائق بديلة للفكر والتحقق بغير السائد، أو هم انعزلوا في أبراج الأكاديميات العاجية، مزجين جل وقتهم في نقاشات معقدة بلغة بعيدة عن حياة الناس وهمومهم، فكأنهم ناد خاص للترفيه لا حصن للفكر المتحرر من الوهم والعرف والدعاية.
لقد أثبتت التجارب التاريخية المتعاقبة أن مجتمعات تسيطر عليها «الأفكار السيئة»، ولا يتم فيها التدقيق بالادعاءات المطلقة على عواهنها أو مساءلة الأدلة بشأنها تنتهي غالباً إلى الانحطاط أو الاندثار الكلي من خلال تجاهل التحولات الكبرى اجتماعية أو طبيعية التي قد تطيح بالحضارة القائمة، أو غلبة الاستقطابات العمياء على المجموعات السكانية فتضيع طاقتها في نزاعات واحترابات أهلية لا طائل من تحتها، أو تساق للموت والفناء في حروب ضد آخرين تحت رايات زائفة وهستيريات كراهية مفتعلة.
وإذا كانت قضية محاربة «التفكير السيء» مسألة بهذه الخطورة لأمن المجتمعات وصحتها وازدهارها وديمومتها، فإنها يجب أن تصبح قرينة المشروع السياسي وركيزة أي حكم وطني رشيد. وهو ما لاحظته الجمعية الفلسفية الأميركية في خضم جائحة (كوفيد - 19) الأخيرة وتضارب المرجعيات والتصورات حول الطرق الأنجع للتعامل مع الوباء وغياب المنطق السليم والأدلة الكافية لادعاءات مختلف الأطراف، مما حدا بها إلى إصدار نداء عاجل للقيادات السياسية للمجتمع مشرعين وتنفيذيين لإطلاق مبادرة قومية شاملة غايتها إعادة الاعتبار لطرق التفكير النقدي في الفضاء العام وبخاصة التعليم، على المدى القصير كجزء من الجهد القومي المشترك لمواجهة تحدي الجائحة، وعلى المدى البعيد لضمان ما وصفته بأمن المجتمع الأميركي وصحته ومستقبله.
لكن غياب مثل تلك المبادرات أو تغول منظومات الإعلام والتعليم الفاسدة في مجتمع ما، وانعزال الفلسفة لا تعفي الأفراد من المهمة ذات البعد الأخلاقي والواجب تجاه الآخرين للتخلص من الكسل المعرفي والبحث عن الأدلة الوافية قبل القبول بالادعاءات المعروضة على الملأ، وعندئذ فقط تستحق تجربة العيش الإنساني أن تعتبر «حياة تم اختبارها» كما قال سقراط الحكيم.