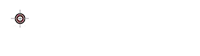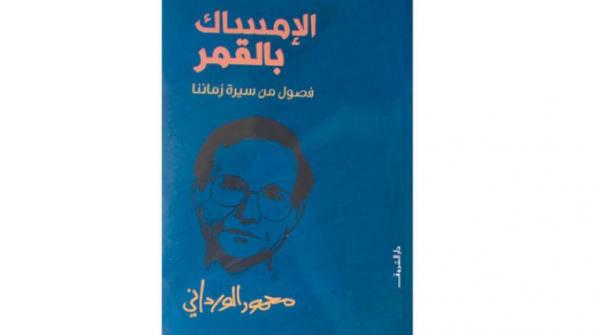
«الإمساك بالقمر»... قبس من سيرة الأمر المحال
قلة من كُتَّاب السيرة والمذكرات يلتزمون بأماكنهم التي كانت لهم في الماضي، بينما يعمد كثيرون إلى توسيع أدوارهم وتقدم الصفوف وإنشاء سردية جديدة تضع ذواتهم في المركز.
وأعذب ما في كتاب محمود الورداني الجديد «الإمساك بالقمر... فصول من سيرة زماننا» هو محمود الورداني نفسه، الذي تعرفه الساحة الأدبية روائياً وقاصاً متصوفاً في سلوكه الاستغنائي. وقد تبدت هذه الروح في الكتاب، وظهرت تلك الذات من حيث كانت الرغبة في إخفائها.
في الكتاب الصادر حديثاً عن دار الشروق بالقاهرة، يروي الورداني تجربة جماعية، من أقسى وأغنى التجارب التي يمكن أن تمر بها أوطان؛ حيث انتهى حلم جماعي كبير بكابوس هزيمة مروعة، لكن ذلك لم يطفئ الأرواح التي ظلت على حيويتها، وتفجر في ذلك الجو كثير من المواهب.
نشر الورداني فصولاً من هذا الكتاب في أسبوعية «أخبار الأدب» تحت عنوان «زمن القليوبي» كان محركها رحيل صديقه المخرج محمد القليوبي عام 2017. وكانت بداية تعارفهما عندما حضر الورداني ابن العشرين أول اجتماع لخلية سرية في بيت القليوبي عام 1970. وقد كان واحداً من جيل الغضب الذي حاول الإمساك بالقمر، فوجد في يده إذلال هزيمة مروعة.
امتد خيط الكتابة عن زمن القليوبي وتشعب، وعند النشر في كتاب صار العنوان «الإمساك بالقمر»، فهل ترددت برأس الورداني أطياف رباعية شاعر العامية الفيلسوف صلاح جاهين...
أنا اللي بالأمر المحال اغتوى
شُفت القمر نطيت لفوق في الهوا
طُلته ما طلتوش إيه أنا يهمني
وليه... ما دام بالنشوة قلبي ارتوى
على كل حال، كان لدى كل من عاش تلك الأيام إحساس بأنه قد أمسك بالقمر، قبل أن تتهاوى شعارات عبد الناصر البراقة على هول هزيمة لم تزل نتائجها تتفاعل إلى اليوم. وربما كان المفجوعون بتلك الهزيمة الكبرى أكثر حظاً ممن واجهوا الهزائم التالية، لأنهم لم يكونوا قد فقدوا ملكة التعبير عن الغضب. رفعوا أصواتهم وفتحت لهم السلطات أبواب السجون بترحابها المعتاد!
يضعنا الكاتب وسط مناخ أدبي وسياسي مفعم بالحياة، أخرج رده على الهزيمة في قصص وروايات وقصائد وأفكار ومنظمات يسارية سرية ضمت كثيراً ممن أُطلق عليهم في مصر تسمية «الأدباء الشبان». وقد كانوا جزءاً من حالة الغضب الوطني من جهة، ومن جهة أخرى لم يكونوا بعيدين عن الغضب العام الذي شمل شباب العالم، فيما عُرف بـ«ثورة الشباب»، لكن النكهة الأساسية كانت مصرية وقومية بعد الهزيمة المروعة لـ3 جيوش عربية أمام إسرائيل.
خرجت في تلك الأثناء مجلة «جاليري 68» المستقلة التي موّلها الأدباء تمويلاً ذاتياً، كما تعاطف معهم عدد من الفنانين وأقاموا معرضاً خصصت حصيلة بيع لوحاته للغرض نفسه. صدرت من المجلة 8 أعداد ثم توقفت، لكنها وضعت بصمتها على الحياة الأدبية بهذه الأعداد الثمانية.
وشهد العام 1968 خروج أول مظاهرة للعمال والطلبة احتجاجاً على المحاكم الصورية لقادة الطيران المسؤولين عن النكسة، بعد عقود من وهم النظام بتأميم المجال العام، كما شهد العام 1969 مؤتمر الأدباء الشبان في مدينة الزقازيق، ومن مساخر المؤتمر - يقول الورداني - انعقاده تحت رعاية شعراوي جمعة وزير الداخلية. وكان هدفه احتواء الأدباء الغاضبين، وهم ما لم يحدث، وصدرت توصيات المؤتمر مذهلة ومتجاوزة كل الأسقف المسموح بها في التعبير في ذلك الوقت.
يعدّ الورداني نفسه وجيله محظوظين بشدة، فمن آثار الهزيمة تم تخفيف القبضة الأمنية والرقابية، وصار بوسع المرء أن يشاهد ما لا يقل عن 4 أفلام جيدة في جمعية الفيلم أسبوعياً، وجمعية سينما الغد، التي خصصت عروضها للأفلام الطليعية، وغير ذلك من المراكز، فضلاً عن المسارح، وبينها مسرح الـ100 كرسي، الذي استضافته جمعية الأدباء، ومسرح الجيب على النيل، شبه المستقل، بعروضه التجريبية المتجاوزة، رغم تبعيته الإدارية للدولة. وبالإضافة إلى كل الكيانات الثقافية المصرية، كانت المراكز الثقافية الأجنبية بالقاهرة تستضيف المعارض التشكيلية والندوات والعروض المسرحية والموسيقية.
وكانت الندوات الأدبية في كل مكان، بعضها مستقل في الأتيليه، وبعضها في دار الأدباء، يذهب إليه الشباب لمجرد السخرية أو من أجل العراك مع المحيطين بيوسف السباعي، أو مع السباعي نفسه، وهناك ندوة الجمعة لنجيب محفوظ في مقهى ريش.
بعد رحيل عبد الناصر المفاجئ، وتولي السادات، يمكننا أن نلمس طريقتين مختلفتين للتعامل مع الثقافة والمثقفين، من باب المنظور فحسب، إذ شهدت الحقبتان اعتقالات الأدباء، لكن تعامل السلطة في الحقبة الناصرية يبدو تعاملاً مع أبناء غاضبين لديهم بعض الحق؛ حيث ازدهر النشاط الثقافي، ونال التعبير الفني مساحات من الحرية، بينما بدأت مع السادات مرحلة ازدراء الثقافة والمثقفين!
جاء السادات بيوسف السباعي وزيراً للثقافة، وهو ألد أعداء اليسار والتقدم والأفكار الحداثية على وجه العموم، وأتى السباعي بطاقم من مسؤولي النشر ينفذون الاتجاه الجديد، انقضوا على مؤسسات الثقافة، يضعون أشباههم من الكتبة الذين عملوا بإخلاص أصحاب ثأر، بدعوى أنهم تعرضوا للتهميش إبان الحكم الناصري.
أُغلقت مجلة الطليعة، وتم استهداف البرنامج الثاني (الثقافي) بالإذاعة، وجرت أكبر حركة تعيين للمعادين للشيوعية على رأس الصحف والمجلات، وأغلق كثير من صالات العرض الفني وتحولت إلى مطاعم.
وكان الرد الحاسم من المثقفين هو مقاطعة منابر إعلامية وثقافية لا تمثلهم، ولم يكن ذلك نتيجة توجيه من تنظيم أو اتفاق، لكنه ردود فعل تلقائية صار لها وجه الإجماع. وشرع الكتّاب في خلق منابرهم المستقلة عبر طباعة الماستر المستقلة، يقول الورداني: «كانت ثورة الماستر استجابة لأشد الظروف إظلاماً واستبداداً في الثقافة المصرية».
لم تقتصر المقاومة على إصدار المجلات الخاصة زهيدة التكاليف، بل ظل الصدام مع السلطة قائماً، ومن أشهر الصدامات بيان المثقفين عام 1973 قبل أشهر قليلة من قرار الحرب، وقد كتبه توفيق الحكيم ووقّعه كبار أدباء مصر، بينهم نجيب محفوظ وأحمد عبد المعطي حجازي لإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب، والمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين الذين شاركوا في انتفاضة يناير (كانون الثاني) التي انتهت باعتصام استمر عدة أيام، وتم فضّه بالقوة في فجر يوم 24 يناير، واعتقال نحو 1000 طالب وطالبة، كان الورداني أحد هؤلاء الطلاب المعتقلين، وقد اتخذ السادات قراراً بمنع الموقعين على بيان المثقفين من الكتابة، وفصلهم من الاتحاد الاشتراكي الذي لم يكونوا أعضاءً به!
ضمّت تلك القائمة 111 اسماً، وتم رفع اسم الكاتبين الشهيرين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ في اللحظة الأخيرة تجنباً للفضيحة، وعرفت مصر ظاهرة الطيور المهاجرة. خرج عدد كبير من الصحافيين والأدباء، بينهم أحمد عبد المعطي حجازي، رجاء النقاش، عبد الرحمن الخميسي، محمود السعدني، غالي شكري، وغيرهم ممن عملوا بصحف لبنانية وكويتية وعربية في أوروبا.
يصعب وصف كتاب الورداني بالسيرة أو المذكرات أو التأريخ الأدبي، ولكنه كل ذلك، بالإضافة إلى فن البورتريه، حول شخصيات كانت لها أدوارها في الثقافة وفي حياة الورداني نفسه، من أساتذة مثل عبد الفتاح الجمل، الروائي المشرف على ملحق جريدة المساء الأدبي، وكان النشر فيه تدشيناً للكاتب. يعد الجمل بحق أستاذاً لجيلي الستينات والسبعينات، اللذين يتناولهما الكتاب. ورغم مقاطعة المنابر المصرية التي استمرت نحو 10 سنوات، كانت جريدة المساء استثناءً لوجود عبد الفتاح الجمل بها.
كذلك، يقدم الورداني بورتريهاً فياضاً بالحب ليوسف إدريس، الذي رآه للمرة الأولى عندما سار خلفه في المظاهرة التي قادها احتجاجاً على اغتيال غسان كنفاني عام 1972، «كنت مجرد نفر صغير السن نشر عدداً من القصص عند عبد الفتاح الجمل في جريدة المساء».
لاحقاً سيتم التعارف بين إدريس والورداني، عندما أصدر الأخير مجموعته القصصية الأولى «السير في الحديقة ليلاً» عام 1984 وأشاد بها يوسف إدريس، وعندما هاتفه ليشكره دعاه إلى مكتبه وناقشه باستفاضة من قرأ بانتباه.
وتتردد في الكتاب أنفاس كثير من الأدباء والفنانين، إبراهيم أصلان، سعيد الكفراوي، عبده جبير، جودة خليفة، صلاح هاشم، أسامة الغزولي، عزت عامر، محمد سيف، وغيرهم.
جيلان من الكتاب، بينهم الأخوان الورداني؛ عبد العظيم الأكبر من جيل الستينات، ومحمود من السبعينات؛ حيث لا تقتصر اللقاءات والندوات على الأتيليه ودار الأدباء والمقاهي، بل في البيوت كذلك، وبينها بيت الورداني، كان شقة مفتوحة على الدوام، يعرف كل أصدقاء الشقيقين مكان المفتاح بين حجرين في الجدار بجوار الباب، وكان الجميع ينادي الأم بـ«الرفيقة نعمات» وغيره كانت هناك شقق متعددة، من بينها شقة حي العجوزة التي تُحكى عن سكانها حكايات أسطورية، ويختلف الرواة حول مستأجرها الأصلي، لكثرة ما كانت تستقبل من المثقفين على قدم المساواة.
يعكس «الإمساك بالقمر» طبيعة مرحلة اختلطت فيها الكتابة بالنضال، بعض الكتّاب جاءوا من التنظيمات إلى الكتابة، والبعض أخذتهم الكتابة إلى التنظيمات. وتلتقي الروايات والقصص الجديدة بالانتفاضات المتكررة، وبينها انتفاضة الخبز في يناير 1977 التي خاض بعدها الورداني تجربة هروب من الشرطة حتى الخريف، وستتكرر عمليات الاعتقال مع كل حركة تظاهر. وسيعرف الورداني الاعتقال مجدداً هو وزوجته بعد زواجه، مرة في بداية عام 1981 وأخرى بعد اغتيال السادات بشهر في العام نفسه. كانت فترات الحبس في عقدي السبعينات والثمانينات قصيرة، لأنها لم تكن على حساب قضايا، بل مجرد تقييد للحرية، وتحقيق الفوضى في حياة الشخص وتفريغ طاقته. لم يتعامل الكاتب مع تلك التجارب بمأساوية، بل يستعيدها بغبطة ذكريات حياة جماعية في التريض والقراءة، وممارسة الديمقراطية بين السجناء، من التصويت على قرار بفعل احتجاجي. كما يصف علاقات إنسانية لطيفة تحدث أحياناً مع ضباط متعاطفين.
ويتوقف الورداني بمذكراته في بداية الثمانينات؛ حيث يعتقد أن ما جرى بعد ذلك ينتمي إلى زمن آخر.
كانت تلك إشارة مقتضبة إلى زمن مختلف تبدلت فيه وسائل المواجهة لدى الطرفين؛ حيث تخلت الدولة عن العصبية وبدأت اللعب الناعم الذي أنتج حالة من السيولة، اختلطت فيها المعاني أو سقطت، لذلك يبدو ما سجّله الورداني ضرورياً عن زمن، بات بعيداً جداً.