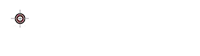كيف انتصر المثقف التنويري على المثقف الأصولي في فرنسا؟
يعد بول بنيشو أحد كبار النقاد الفرنسيين في القرن العشرين. ولكن الشهرة في العالم العربي ذهبت إلى رولان بارت وغطت عليه بل طمسته كلياً. وهذا ظلم كبير في الواقع بل خطأ فادح. لماذا أقول ذلك؟ لأن مؤلفات بول بنيشو لا تقل أهمية عن مؤلفات رولان بارت هذا إن لم تزد فيما يخص شرح كيفية ولادة الحداثة وانتصارها على القدامة في فرنسا. وهذا موضوع يهم المثقف العربي أيضاً، بل إنه موضوع الساعة. علاوة على ذلك فإن هذا الناقد الكبير يشرح لنا كيف تغلبت المسيحية الليبرالية التنويرية على المسيحية الأصولية الظلامية بعد معارك طاحنة وجهد جهيد. إن الاطلاع على مؤلفات هذا الناقد الفذ يساعدنا على فهم التحولات التي طرأت على الأدب الفرنسي في مرحلة حاسمة من تاريخه. ومعلوم أن هذا الرجل عاش عمراً مديداً بين عامي 1908 – 2001 (أي 92) سنة. وقد أمضى جل حياته في دراسة الشعراء والأدباء والمفكرين الذين عاصروا التحولات الكبرى التي صنعت فرنسا الحديثة من أمثال: شاتوبريان، وأوغست كونت، ولامارتين، وفيكتور هيغو، وألفريد دو فيني، وجيرار دو نيرفال، وألفريد دو موسيه، وآخرين كثيرين. وهو لا يدرس هؤلاء الشعراء الكبار من الناحية الفنية أو الجمالية فقط وإنما أيضاً من الناحية الآيديولوجية والسياسية. فالشعر ذو مضمون فكري أيضاً وليس فقط جماليات تطربنا وتنعشنا. إنه يشرح لنا كل ذلك بالتفصيل من خلال كتبه المتلاحقة التالية: أولاً كتاب بعنوان «سيامة الكاتب الحديث وانتصاره على الكاهن القديم بين عامي 1750 - 1830: دراسة عن استهلال عهد سلطة روحانية علمانية في فرنسا». الكتاب صادر عام 1973 في نحو خمسمائة صفحة. ثانياً كتاب بعنوان «زمن الأنبياء: عقائد العصر الرومانطيقي» الصادر عن «غاليمار» في 589 صفحة من القطع الكبير، وقد نال جائزة الأكاديمية الفرنسية عام 1978. ثالثاً كتاب بعنوان «القادة الرومانطيقيون» الصادر عن «غاليمار» عام 1988 في 553 صفحة وقد نال جائزة الأكاديمية الفرنسية أيضاً عام 1988. رابعاً كتاب بعنوان «مدرسة الخيبة والمرارات» الصادر عن «غاليمار» عام 1992 في 615 صفحة.
إن هذه الكتب الأربعة الضخمة المتلاحقة بعضها وراء بعض تمثل تحفة نقدية فكرية من أروع ما يكون. إنها توضح لنا كيف حل الشاعر أو الكاتب أو الفيلسوف محل الكاهن أو رجل الدين في فرنسا الحديثة التي تشكلت بعد الثورة الفرنسية. ولكنّ ذلك لم يحصل دفعة واحدة وإنما على دفعات متتالية طيلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. عندئذ حلت الثقافة الروحية العلمانية محل الثقافة الدينية الكهنوتية لرجال الدين الأصوليين. كيف حصلت هذه العملية الهائلة التي تمثل قطيعة الحداثة؟ وهل كان مخاض الحداثة صعباً، مراً، عسيراً؟ بمعنى آخر: كيف حل الفكر العلماني الحداثي التقدمي محل الدوغمائيات المتحجرة للأصولية الكنسية القديمة؟ ثم أخيراً: كيف نهض البنيان الجديد على أنقاض العالم القديم؟ هذه هي بعض التساؤلات الكبرى التي يطرحها هذا الناقد الفذ الذي غطت على شهرته صرعة البنيوية الشكلانية الفارغة والعقيمة في نهاية المطاف. ينبغي العلم أن هذه التساؤلات تخص المثقف العربي بالدرجة الأولى حالياً. وذلك لأننا سوف نشهد ذات الظاهرة أو ما يشبهها عما قريب. سوف نشهد ذات المخاض الطويل العسير. لا يعتقدن أحد أن كلام رجال الدين المتزمتين وشيوخ الفضائيات سوف يظل مهيمناً علينا إلى أبد الآبدين. لا يعتقدن أحد أن فهم الإخوان المسلمين القسري والتوتاليتاري للإسلام سوف يظل مسيطراً على الشارع العربي حتى قيام الساعة! لا يعتقدن أحد أن دين «لا إكراه في الدين» سوف يظل مفهوماً بشكل مضاد لروحه وجوهره. كل هذا سوف يتم تكنيسه في السنوات القادمة عندما ينتصر الفهم التنويري للإسلام على الفهم الظلامي. عندئذ سوف يحل المثقف الحداثي أو الفيلسوف العربي محل الشيخ التقليدي المهيمن على العقلية الجماعية منذ مئات السنين. عندئذ سوف ينتصر المثقفون العرب على شيوخ الفضائيات. وسوف يشرحون الدين الحنيف بطريقة مختلفة كلياً: أي طريقة متجددة، حرة، منعشة. عندئذ سوف يحل محمد أركون محل محمد عمارة، أو حسن حنفي محل يوسف القرضاوي، أو العقاد محل حسن البنا، أو طه حسين محل سيد قطب، إلخ. هنا يكمن الرهان الأعظم لكل ما يحصل حالياً. وراء الأكمة ما وراءها. لو أننا ترجمنا كتب بول بنيشو لكنا عرفنا كيف حصلت نقلة الحداثة بكل تجلياتها ومراحلها وتعقيداتها. وهي نقلة أو قطيعة سوف تحصل عندنا أيضاً مثلما حصلت في أوروبا قبل مائتي سنة. ولكنّ هذا لا يعني أن حداثتنا ستكون نسخة طبق الأصل عن حداثة أوروبا! ولا يعني أن الثورة الفرنسية هي النموذج الأوحد للتغيير. فنحن لسنا بحاجة إلى مقصلة وعنف ودماء غزيرة تملأ شوارع عواصمنا كما ملأت شوارع باريس. هناك طرق أخرى للتغيير. هناك أسلوب الإصلاح المتدرج والحكم الرشيد على الطريقة الإنجليزية مثلاً. أكتب هذه الكلمات وأنا أشهد بأم عيني كيف اعتلى الملك المحترم المحبوب تشارلز الثالث عرش إنجلترا في أعرق دولة ديمقراطية في العالم.
لكن لنعد إلى فرنسا. من المعلوم أن قادة الحركة الشعرية والأدبية الفرنسية من أمثال لامارتين وألفريد دو فيني وفيكتور هيغو وسواهم رافقوا الثورة الفرنسية وأحداثها الضخمة أو قلْ تلوها مباشرة. بمعنى آخر فإنهم شهدوا احتضار العالم القديم وولادة العالم الجديد على أنقاضه. لقد انعكس زلزال الثورة الفرنسية على أدبهم شعراً ونثراً. ويمكن القول دون مبالغة إن الثورة الفرنسية كانت زلزالاً كبيراً على الصعيد السياسي وإن نتاجهم كان زلزالاً كبيراً على المستوى الشعري والأدبي والفكري. زلزال الفكر استبق على زلزال السياسة. ولكن ماذا حصل مؤخراً في العالم العربي؟ العكس تماماً. انتفاضات شعبية عارمة تُوِّجت بحكم إخوان مسلمين! وهم يعدون ذلك ثورة مجيدة! بل يعدون إفشالها بمثابة ثورات مضادة! يا إلهي كيف انقلبت الأمور عاليها سافلها...؟
على أي حال لم يكن فيكتور هيغو شاعراً فقط بالمعنى الفني والغنائي الرائع للكلمة وإنما كان أيضاً مفكراً اجتماعياً وسياسياً منخرطاً في هموم عصره وقضاياه. وإلا فما معنى رواية «البؤساء»؟ عندئذ أصبح الشاعر هو القائد الرائد لأمة بأسرها. الشاعر الكبير ذو حدس نبوئي استشرافي يمهد للشعب الطريق. ومعلوم أنه كان ضد الكهنة والمطارنة والخوارنة لأنهم كانوا يمثلون حزب الرجعية والجمود في وقته. هذا لا يعني أنه كان ملحداً. أبداً، أبداً. كان يقول: «أؤمن بوجود الله أكثر من إيماني بوجودي الشخصي»! إنه إله الحق والعدل والخير والجمال. وبالتالي فمعاداة الأصولية الظلامية لا تعني الإلحاد كما يتوهم الكثيرون وإنما تعني الإيمان بشكل آخر، شكل جديد لا قمعي ولا إكراهي ولا ظلامي. «لا إكراه في الدين» كما يقول القرآن الكريم. كان فيكتور هيغو ناقماً على رجال الدين في عصره بسبب تزمتهم وتحجرهم وتكالبهم على الأرزاق والأموال. فيما بعد سوف يتطورون ويستنيرون كثيراً ولكن ليس في عصره. فيما بعد سوف تتصالح المسيحية مع الحداثة بعد صراع طويل ومرير. وهذه هي أكبر ثورة روحية وفكرية تحصل في التاريخ البشري. انظروا إلى البابا فرنسيس الذي يمثل أحد الضمائر الكبرى لعصرنا. لا يوجد أي أثر للتزمت الديني أو التكفير اللاهوتي لديه وإنما العكس هو الصحيح. إنه يفهم الدين بشكل مستنير منفتح ويمد يده بكل صدق إلى عالم الإسلام ويوقّع على «وثيقة الأخوة الإنسانية» مع شيخ الأزهر في أبوظبي.
يقصد المؤلف بأطروحته الأساسية أن هيبة الشعراء والكتاب والفلاسفة حلت محل هيبة الكنيسة والكهنة والمطارنة في القرن التاسع عشر. ولكنّ المشكلة هي أنه ليس من السهل أن تحل سلطة روحية جديدة محل سلطة روحية قديمة راسخة الجذور منذ مئات السنين. ومعلوم أن سلطة الكنيسة كانت مهيمنة على العقول في فرنسا وعموم أوروبا منذ 1500 سنة على الأقل. وكانت تُشعر الناس بالسكينة والطمأنينة وبخاصة عندما يُبتلون بالمصائب والويلات والفقر والجوع والأمراض.
ولذلك فإن انهيار هيبة الأصولية المسيحية ترك فراغاً كبيراً بل أحدث هلعاً في النفوس. وقد حاول الشعراء والكتاب والفلاسفة الكبار سد الفراغ ومعالجة الوضع بقدر الإمكان. ولذلك يمكن القول إن الشعر حل محل الدين إلى حد ما بعد زلزال الثورة الفرنسية. لقد حل محله كعزاء للنفوس الحائرة، النفوس القلقة الضائعة.
أخيراً للحقيقة والتاريخ، ينبغي أن نضيف ما يلي: الدين لم ينته كلياً في أوروبا والغرب كله على عكس ما نتوهم. وإنما الشيء الذي حصل هو أن المسيحية الليبرالية المستنيرة حلت محل المسيحية الأصولية القديمة كما ذكرنا سابقاً. ولهذا السبب اطمأنت الروح الأوروبية بعد أن كانت قد تخلخلت وتزعزعت وارتعبت إلى أقصى حد ممكن بسبب زلزال الثورة الفرنسية. وبالتالي فالدين لم ينتهِ في عصر الحداثة وإنما انتهى فقط مفهومه التكفيري الظلامي والطائفي المتعصب. انتهت محاكم التفتيش والحروب الطائفية الكاثوليكية - البروتستانتية الرهيبة التي ذهب ضحيتها الملايين. انتهى عصر التكفير الداعشي، إذا جاز التعبير. وهذا أعظم إنجاز حققه عصر التنوير الكبير وكذلك الثورة الفرنسية على أثره. وهذا ما سيحصل في العالم العربي يوماً ما. سوف يحل الإيمان الذي يُنعش محل الإيمان التكفيري الذي يقتل. لقد توقفت مطولاً عند هذه الإشكالية الكبرى في كتابي الصادر مؤخراً عن «دار المدى» في بغداد - العراق بعنوان «الإسلام في مرآة المثقفين الفرنسيين».